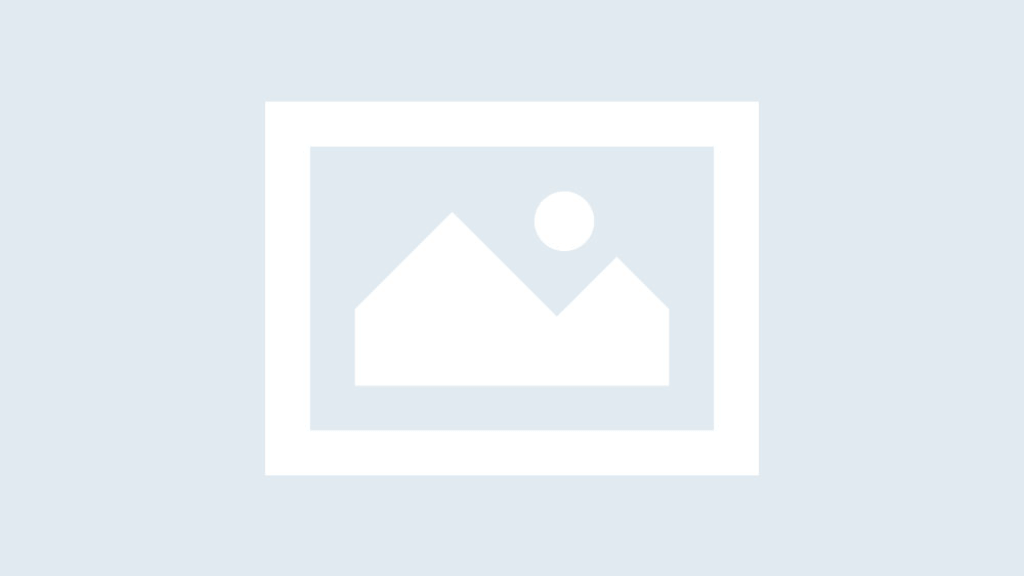اتفاق الطائف: في الإصلاحات والدولة القادرة المفترضة
منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامًا، يظل اتفاق الطائف الركيزة الأساسية للنظام اللبناني، رغم التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدها لبنان والمنطقة. تم توقيع الاتفاق عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية، لكنه لم يكن مجرد وثيقة دستورية لتنظيم توزيع السلطات، بل جاء كتسوية سياسية إقليمية-داخلية أعادت رسم توازن القوى وربطت بناء الدولة بمصالح محلية ودولية متشابكة.
ورغم أن الطائف أنهى الحرب رسميًا، إلا أنه لم يؤسس لنظام سياسي مستقر أو منتج. فبدل أن يطلق مرحلة إصلاح مؤسساتي حقيقي، كرّس منطق المحاصصة الطائفية كآلية لإدارة الدولة، ما حوله من اتفاق لإنهاء النزاع إلى صيغة تعيد إنتاجه بصور مختلفة.
في هذا الإطار، برز خطاب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الجهادي نبيل قاووق والقائد الجهادي سهيل الحسيني “السيد أحمد” الذي شدد فيه على أن «الطائف ليس وجهة نظر، بل اتفاق، وليس مطية لموازين القوى»، مؤكدًا أن المشكلة ليست في النصوص، بل في الممارسة السياسية التي فرغت الاتفاق من مضمونه الإصلاحي.
وفي هذا السياق يشير مرجع وزاري سابق في حديث لموقع المنار، إلى أن «النقاش حول الطائف لا يقتصر على النصوص، بل على قدرة الدولة على تطبيقه بصدق وحماية السيادة الوطنية»، ما يعكس الحاجة المستمرة لربط التاريخ بالواقع الراهن.
خلفية الاتفاق: لحظة صناعة النظام الجديد
الطائف: نهاية الحرب لا بداية الدولة
وقع اتفاق الطائف في 22 تشرين الأول 1989، لوضع حد رسمي لحرب أهلية استمرت خمسة عشر عامًا وإعادة ترتيب السلطة السياسية في لبنان. المصادقة البرلمانية عليه في 5 تشرين الثاني 1989 كرّست نهاية النزاع شكليًا، لكنه لم يتحول مباشرة إلى استقرار سياسي أو بناء مؤسساتي متين.

وفي هذا الإطار يوضح د. جهاد إسماعيل في مقابلة مع موقع المنار: أنّ «اتفاق الطائف جاء لإنهاء النزاع المسلح أولًا، ولم يُصمم كنقطة انطلاق لإصلاح مؤسسات الدولة بشكل شامل. التحدي اليوم هو كيفية إعادة إنتاجه بطريقة تراعي السيادة الوطنية والمعادلات الراهنة».
التوازن الطائفي مقابل الدولة المدنية
كرّس اتفاق الطائف تعديل التوازن الطائفي داخل البرلمان، بحيث أصبح التمثيل بين المسلمين والمسيحيين متساويًا، وأقرّ توزيع المناصب وفق الطوائف. وفي الوقت نفسه، ذكر إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، دون وضع آليات تنفيذية واضحة، ما جعل الدولة المدنية هدفًا نظريًا أكثر منه واقعًا ملموسًا.

دور الوجود السورية في التطبيق
نص الاتفاق على دور سوريا كطرف ضامن، مما منحها قدرة واسعة على التدخل في السياسة اللبنانية. ومع استمرار الوجود العسكري السوري بعد الاتفاق، تحقّق الاستقرار الظاهري، لكنه بقي مرتبطًا بقدرة طرف خارجي على ضبط التوازنات السياسية، ما أعطى الاتفاق طابعًا مشروطًا بالوصاية.
وهنا يشير المرجع الوزاري السابق الى أنّ «الوجود السوري ساعد على حفظ التوازن، لكنه أيضًا أعاق استقلال القرار اللبناني، ما خلق تحديات لاحقًا في تطبيق الطائف بشكل كامل».
قراءة في خطاب الشيخ نعيم قاسم
قدّم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم رؤية متميزة تتجاوز القراءات التقليدية لاتفاق الطائف. فهو يرى أن الطائف ليس مجرد وثيقة لتقسيم السلطة بين الطوائف، بل إطار سياسي محدود ينجح في إنهاء الحرب وإرساء توازن داخلي بين الفصائل اللبنانية. وبحسب الشيخ نعيم، فإن الطائف لم يُعدّ ليكون أداة لتعطيل المشروع الوطني أو قمع الحق في الدفاع عن لبنان، بل يجب فهمه كجزء من مشروع أوسع يشمل السيادة والاستقلال الوطني.

وأكد الشيخ نعيم أن المقاومة اللبنانية ليست مخالفة للاتفاق، بل تشكّل ركيزة أساسية في المشروع الوطني، فهي تعكس حق لبنان في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من تحقيق توازن القوى الواقعي في الداخل اللبناني. وفي هذا السياق، شدّد على أن الطائف قابل للتأويل في بعض بنوده بما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية والحق في الدفاع والمقاومة، دون المساس بتوازن الطوائف أو صلاحيات المؤسسات الدستورية.
وأضاف الشيخ نعيم أن قراءة الطائف بشكل جامد، مع الاقتصار على النصوص دون مراعاة التغيرات الإقليمية والداخلية، يفرّغ الاتفاق من مضمونه ويحول وثيقة تاريخية إلى أداة للمحاصصة التقليدية. ولذلك، دعا إلى إعادة إحياء روح الاتفاق، أي العمل على تعزيز العدالة، وتمكين الدولة من ممارسة سيادتها، مع الحفاظ على الحق المشروع للمقاومة في حماية لبنان، بما يتوافق مع مبدأ الدولة القادرة على الدفاع عن نفسها.
كما بيّن الشيخ نعيم قاسم أن هذه المقاربة لا يعني تعديل النصوص الرسمية للطائف، بل فهمها ضمن سياقها التاريخي وربطها بالمعطيات الحالية على الأرض. فالهدف من ذلك هو خلق توازن ديناميكي بين نصوص الطائف والواقع الوطني بعد التحرير، بحيث يصبح الطائف أداة لتعزيز الوحدة الوطنية والمقاومة والحقوق المشروعة، بدل أن يظل محصورًا في إطار تقليدي يكرّس الانقسامات الطائفية ويحدّ من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات سيادية مستقلة.
الطائف كنص في مواجهة الواقع
وعلى الرغم من القيمة الرمزية الكبيرة التي اكتسبها اتفاق الطائف عند توقيعه، تكشف مراجعة تطبيقه على مدى العقود الثلاثة الماضية فجوة واضحة بين نصوصه الدستورية والواقع السياسي اللبناني. البنود التي نصّت على اللامركزية، إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ لم تُطبّق عمليًا، مما جعل الكثير من أهداف الاتفاق في بناء الدولة المدنية والنظام المؤسساتي مجرد خطاب نظري لم يترجم إلى واقع ملموس. في المقابل، تم الإفراط في تطبيق بعض البنود بما أتاح تعزيز المحاصصة التقليدية وتثبيت مواقع النفوذ للطوائف والأحزاب الكبرى، ما حول الاتفاق من وثيقة وفاق وطني إلى أداة لضمان بقاء القوى التقليدية في السلطة ومصالحها.

وفي حديث لموقع المنار، يؤكد الدكتور جهاد إسماعيل أن “الطائف من الناحية الدستورية قابل للتطوير، لكنه لم يُطبق بالكامل. أي تطوير يجب أن يتم ضمن القنوات الدستورية، بعيدًا عن أي تدخل خارجي”، مشددًا على أن نصوص الطائف توفر إطارًا قانونيًا يمكن الاستناد إليه لإجراء إصلاحات تدريجية، شرط الالتزام بالشرعية الوطنية واحترام المؤسسات. ويضيف إسماعيل أن إعادة النظر في التطبيق يجب أن تراعي التوازن بين الطوائف، مع تعزيز مبدأ الكفاءة في إدارة الدولة، لضمان أن يكون أي تطوير شاملًا وعادلاً، ويخدم مصالح المواطنين بدل أن يخضع لضغوط خارجية أو صراعات حزبية.
الطائف بعد المقاومة والتحرير
ومع انتصار المقاومة في الجنوب عام 2000، تغيّرت معادلات القوة على الأرض. الطائف، الذي صاغ إطارًا سياسيًا قائمًا على التوازنات التقليدية، لم يواكب هذه التحولات، ما خلق فجوة بين المعادلة السياسية التي افترضها الاتفاق والمعادلة الميدانية التي فرضتها المقاومة. في ظل غياب مسؤولية الدفاع عن مؤسسات الدولة
ووفق المرجع الوزاري السّابق: “المقاومة أعادت توزيع القوة، لكن الطائف بقي أسير معادلات ما قبل التحرير، مما يستدعي قراءة جديدة تجمع بين نصوص الاتفاق والقدرة الوطنية الفعلية”.
الطائف والسيادة المفقودة
في التسعينات، كان الوجود السوري عاملًا أساسيًا في تنفيذ نصوص الطائف وضبط التوازنات الداخلية. مع انتهاء الوجود العسكري السوري، حلت محلها ضغوط خارجية وسياسات مالية دولية، ما كشف محدودية قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستقلة، بينما استمرت المحاصصة كأداة لتعطيل الدولة وتثبيت نفوذ الفئات التقليدية.
كما يشير د. جهاد إسماعيل الى أنّ “تحرير الطائف من هذه الوصايات لا يعني إسقاطه، بل استعادة قدرة الدولة على اتخاذ قراراتها ضمن الإطار الدستوري، بما يعزز السيادة ويوازن بين الالتزام بالتمثيل الطائفي وفرض السيادة الوطنية”
إعادة صياغة مفهوم الوفاق الوطني
الوفاق الوطني الذي صيغ في الثمانينات كان حلًا مرحليًا لإنهاء النزاع، لكنه لم يُصمّم لتجاوز الانقسامات الطائفية أو لضمان تكافؤ الحقوق بين المواطنين.
في هذا السياق، يقدّم الشيخ نعيم قاسم رؤية تربط بين مفهوم الوفاق الوطني وبناء دولة قادرة وعادلة، بحيث تستثمر موازين القوى الحالية، بما فيها قوة المقاومة، في تعزيز قدرة الدولة على حماية حقوق المواطنين واستقلال القرار الوطني.
ويُكمّل أرشيف خطابات الشهيد السيد عباس الموسوي، الأمين العام لحزب الله السابق، موقف الحزب من اتفاق الطائف منذ مطلع التسعينيات. ففي خطاب له بتاريخ 15 تشرين الأول 1992، شدّد على رفض الطائفية السياسية بوصفها آلية تحصر السلطة ضمن فئات محددة، مؤكدًا أن الحقوق الوطنية والمقاومة جزء لا يتجزأ من السيادة اللبنانية. وورد في الخطاب:
“الطائف جاء لتثبيت توازنات سياسية مؤقتة، لكنه لم يُصمّم لقيادة لبنان نحو سيادة حقيقية. إن المقاومة والدفاع عن الأرض والكرامة الوطنية ليست مجرد خيارات سياسية، بل واجب دستوري يحمي الدولة والمواطنين”.
كما أكد السيد عباس الموسوي في مقابلة نُشرت على موقع المنار بتاريخ 12 أيار/مايو 1995، أن الطائف يمكن إعادة إنتاجه بطريقة تراعي الواقع الوطني الجديد، بحيث لا يصبح مجرد آلية لتقاسم الحصص، بل إطارًا يوازن بين احترام الطوائف وتعزيز سيادة الدولة واستقلال القرار الوطني.
وشدد في السياق نفسه على أهمية إلغاء الطائفية السياسية واعتماد المواطنة القائمة على الكفاءة، باعتبارها المدخل الحقيقي لبناء دولة عادلة تُنصف جميع مكوّناتها دون تمييز أو محاصصة.وأضاف: “دمج الطائف مع مشروع المقاومة الوطني يتيح للبنان مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بشكل متوازن وفعّال”.
بهذه الطريقة، يظهر الموقف الرسمي لحزب الله منذ التسعينيات، ويُقدّم قراءة متسقة تربط بين الطائف، السيادة الوطنية، والحق في المقاومة، بما يعكس رؤية استراتيجية طويلة المدى للحفاظ على الدولة والحقوق الوطنية.
خلاصة
لقد مثل اتفاق الطائف نقطة تحول تاريخية في مسار لبنان، إذ أنهى مرحلة حرب أهلية طويلة وأرسى قواعد لتوزيع السلطة بين الطوائف المختلفة، وحافظ على استقرار الدولة على المستوى الرسمي. ومع مرور الوقت، أظهر التطبيق العملي للاتفاق وجود فجوات بين ما نص عليه الاتفاق وبين الواقع السياسي والميداني، ما كشف عن تحديات إعادة بناء مؤسسات قادرة على اتخاذ القرارات السيادية بشكل كامل.
في ظل التحولات الكبرى التي شهدها لبنان بعد تحرير الجنوب وانتصارات المقاومة، تبيّن أن المعادلات السابقة للطائف لم تعد تعكس الواقع العلمي الجديد. وأصبح واضحًا أن الطائف، رغم أهميته التاريخية والسياسية، يحتاج إلى قراءة شاملة تتوافق مع المعطيات الراهنة، بما يضمن استمرار توازن الطوائف واحترام المؤسسات، وفي الوقت نفسه تمكين الدولة من أداء مهامها وحماية حقوق جميع المواطنين.
وبالنظر إلى تجربة لبنان منذ توقيع الطائف، يظهر أن المسار الوطني يتطلب الحفاظ على إطار الاتفاق التاريخي مع تطوير آليات التطبيق بحيث يستوعب التطورات الداخلية والخارجية، ويحقق الوفاق الوطني القائم على العدالة والمساواة بين المواطنين، ويتيح للدولة ممارسة سلطاتها بحرية ضمن إطار دستوري متكامل يقوم على الدولة القادرة والعادلة
بذلك، يظل اتفاق الطائف وثيقة مركزية في تاريخ لبنان، لا يمكن تجاهلها أو إلغاؤها، لكنها أيضاً تمثل مدخلاً لإعادة تنظيم العمل السياسي والمؤسساتي بطريقة تراعي مصالح الدولة والمواطنين، وتوازن بين حقوق الطوائف ومتطلبات السيادة الوطنية.
المصدر: موقع المنار